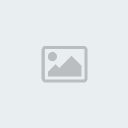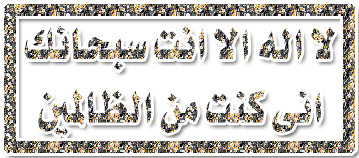ما على وَجْهِ الأرض أحدٌ يَنجو من البَلاء، وَيُعصَم من الابتلاء، ولو كان من الرُّسل الأصفِياء، ومن أولي العزم من الأنبياء. فالدنيا دار عمل ليست بدار حساب، ودارُ امتحان ليست بدار جزاء.
إن من صُنُوف البلاء التي لا ينتهي منها عجبنا ما حلَّ ببعض الأنبياء والمرسلين من الآلام والأسقام، ومن الرَّزايا والبلايا ما وصفوه بقولهم: هذه الدنيا نصَبَ فيها آدم، وناحَ فيها نوح، ورُميَ في النار إبراهيم الخليل، وأُضْجِع للذبْح إسماعيل، وبِيْع يوسف بثمنٍ بَخْسٍ، ونُشر بالمناشير زكريا، وذُبِح الحَصُور يحيى، وأُضْنِيَ بالبلاء أيوب، وزاد على القدر بكاءُ داود، وهام مع الوحوش عيسى، وعانَى الفقر والجوع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
فكيف يظنُّ الجُهلاء أن البلاء والعذاب في الدار الفانية لا يهبط إلاّ فوق رؤوس العصاة والمجرمين، والخطّائين المذنِبين؟! والله تعالى بيَّن لنا السُّنَن الربّانية في الحياة الدنيا كما في قوله: {أَمْ حسِبتُم أن تدخُلوا الجنّة ولـمّا يأتِكُم مَثَلُ الذينَ خَلَوا مِن قبلِكُم مَسَّتْهُمُ البأساءُ والضرّاءُ وزُلزِلوا حتى يقولَ الرسولُ والذينَ آمَنوا معه متى نصْرُ اللهِ ألَا إنّ نصر الله قريب} (البقرة: 214).
إن الله تعالى قَضَت سُنَّتُه بأن يَبْتليَ المؤمنَ في دُنياه بما يَسُرُّه وما يسوؤه، وإنّ من أشدِّ المؤمنين ابتلاءً الأَمثل فالأَمثَل، وأهلُ الإيمان يُبتَلون على قدر إيمانهم، وعلى قدرِ العزائمِ والهِمم تأتي البلايا والمِحن! فمن يُرد الله به خيراً يُصِبْ منه، ومن كان في دينه صلباً، وفي إيمانه صادقاً اشتدَّ عليه البلاء عن سواه.
لا شك بأن الشّدائدَ تكشفُ معادِن الناس كما تكشفُ النارُ الذَّهب والماس، فبالبلاء يُعرَف الصّادقُ من المنافق، والطَّيِّبُ من الخبيث، والله سبحانه يقول: {ما كان اللهُ لِيَذَرَ المؤمنينَ على ما أنتُم عليهِ حتى يَمِيزَ الخبيثَ من الطيِّب} (آل عمران: 179).
والشاعر يقول:
جزى اللهُ الشّدائد كلَّ خيرٍ * * * * * وإن كانت تُغصِّصُني بِرِيقي
وما شُكري لها إلا لأني * * * * * عرفتُ بها عدوِّي من صديقي
ومِن نِعم الله على العبد المؤمن في بلائه أن الله تعالى اختارَهُ ليُعاقِبَه بذنوبه في دنياه، وعذاب الدنيا مهما عَظُم هو أهون من عذاب الآخرة مهما صَغُر!.
إن من روائع حِكم الفاروق عمر رضي الله عنه قوله: «ما ابتُليتُ ببلاءٍ إلا كان لله تعالى عليَّ فيه أربعُ نِعَم: إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظَم، وإذ لَم أُحرَم الرضا به، وإذ أرجو عليه الجزاءَ الجزيل والثوابَ العظيم».
إن من غرائب ما تُصابُ به الدعوة من خُطوبٍ وفِتن، ما يدلُّ على جَهل رجالها بِحِكَم الله تعالى في المِحَن، وبأسرار المعاني في النّوازل والنّوائب، فلولا أن الدنيا دارُ اختبار لما خُلِقت الأمراضُ والأَكدار، ولما ضيَّقَ الله العيش على الأنبياء الأَطهار، فمَن منهم خَلَتْ حياتُه مِن الأمراض والأَسقام، ومن الخُطوب والكروب، وإن غَفِلْتَ عَن هذه الدّلائل فعليك مراجعة ما أصاب النبيَّ الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم الذي صابر الفقرَ والتعذيب والتكذيب ومرض الحبيب.
إن رجال الدعوة الصالحين تراهُم يَستبشرون بسُنن الله تعالى عند حُلول النَّصر والتّمكين، ويرون في ذلك رضواناً من الله تعالى ونصراً مُبيناً، ولا يحسبون أنه قد يكون من الابتلاء والفتن! وتراهم يغفلون عن سُنن الله تعالى عند حدوث الهزيمة والفشل، فيحسبون في ذلك انتقاماً وعقاباً ربّانياً، ولا يحسبون أنه قد يكون من البلاء والمحن!.
إن دُعاة الإسلام لن يبلُغوا مستوى الاتّعاظ بما يواجِهُهم من نجاح وفشل حتى يُدركوا حقائق السُّنَن في الجماعات والأُمم في أحداث الفِتن والمِحَن.
-----------------
* المصدر : مجلة "الأمان" اللبنانية.









 اليوم في 6:42 am من طرف رضا البطاوى
اليوم في 6:42 am من طرف رضا البطاوى