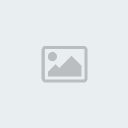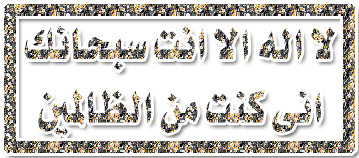اعلم أن حقيقة الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه، مع الأخذ في الأسباب، وهو مندوب إليه بهذا المعنى بخلاف الطمع فإنه محرم، لأنه أصل الخير مع ترك أسبابه.
والعارفون المحققون لم يبق لهم أمل يتعلقون به ولا فرض يستوقفهم فيقفون معه، ولهذا أشار سيد الكمّل صلى الله عليه وسلم في إخباره عن نعيم أهل الجنة حيث قال: (لهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر). فإذا كان ذلك لهم من حظ النفس في الجنة فما ظنك بما لهؤلاء من حظ قلوبهم من الله عز وجل.
قال أبو حبيب البدوي رحمه الله تعالى: لم نر خيراً قط إلا من ربنا، فما لنا نكره لقاء من لم نر خيراً قط إلا منه.
الرجاء الأمل، وسببه الدوام على الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: {مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآَتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (العنكبوت: 5)، وقال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (الكهف: 110)، أي شركاً خفياً أو جلياً.
وحقيقة الرجاء تعلق القلب بمحبوب سيحصل في المستقبل، وكما أن الخوف يقع في مستقبل الزمان، فلذلك الرجاء يحصل لما يؤمل وقوعه في زمن الاستقبال، وبالرجاء عيش القلوب واستقلالها.
والفرق بين الرجاء والتمني: أن التمني يصاحبه الكسل، ولا يسلك طريق الجهد والجد، وبعكسه صاحب الرجاء، فالرجاء محمود، والتمني معلول، وقد تكلموا في الرجاء، فقال شاه الكرماني: علامة الرجاء حسن الطاعة.
وقال ابن خبيق: الرجاء ثلاثة: رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولها، ورجل عمل سيئة ثم تاب منها فهو يرجو المغفرة، والثالث الرجل الكاذب يتمادى في الذنوب ويقول: أرجو المغفرة، ومن عرف نفسه بالإساءة، ينبغي أن يكون خوفه غالباً على رجائه.
وقيل: الرجاء ثقة الجود من الكريم الودود، وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال، وقيل: هو قرب القلب من ملاطفة الرب، وقيل: هو سرور الفؤاد بحسن المعاد، وقيل: هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى.
قال الروذباري: الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت.
سئل أبو عاصم الأنطاكي: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان، ألهم الشكر راجياً لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا، وتمام عفوه في الآخرة.
وقال أبو عثمان المغربي: من حمل نفسه على الرجاء تعطل، ومن حمل نفسه على الخوف قنط، ولكن من هذه مرة، ومن هذه مرة، بحيث يداوي الرجاء بالخوف وبالعكس.
عن بكر بن سليم الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس رحمه الله في العشية التي قبض فيها، فقلنا: يا أبا عبدالله كيف تجدك؟ فقال: ما أدري ما أقول لكم! غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى مالم يكن لكم في حساب. ثم ما برحنا من مكاننا حتى أغمضناه.
وقال يحيى بن معاذ: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إليّ ساعة يكون فيها لقاؤك.
وقيل إن مجوسياً استضاف الخليل إبراهيم عليه السلام فقال: إن أسلمت أضيفك، فقال المجوسي: إذا أسلمت فأي سنة تكون لك عليّ؟ فمر المجوسي فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغييره دينه؟ نحن منذ سبعين سنة نطعمه على كفره، فلو أضفته ليلة ماذا عليك؟ فمر إبراهيم عليه السلام خلف المجوسي وأضافه، فقاله له المجوسي: أي الشيء كان السبب في الذي بدا لك؟ فذكر له ذلك! فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني؟ وفي رواية: نعم الرب رب يعاتب نبيه في عدوه، ثم قال: اعرض علي الإسلام، فأسلم.
رؤي أبو سهل الصعلوكي في المنام، على هيئة حسنة لا توصف، فقيل له: يا أستاذ بم نلت هذا؟ فقال: بحسن ظني بربي، بحسن ظني بربي.
ورؤى مالك بن دينار في المنام فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: قدمت على ربي بذنوب كثيرة، محاها عني حسن ظني به تعالى.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً، وإن اقترب إليّ ذراعاً اقتربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) أخرجه البخاري ومسلم.
-----------------------------------------------
* بتصرف - نقلا عن كتاب (الجد في السلوك إلى ملك الملوك) للشيخ أسعد محمد الصاغرجي.









 اليوم في 6:42 am من طرف رضا البطاوى
اليوم في 6:42 am من طرف رضا البطاوى